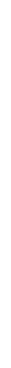الحمد لله ملأ بنور الإيمان قلوب أهل السعادة، فأقبلت على طاعة ربها منقادة، فحققوا حسن المعتقد وحسن العمل وحسن الرضا وحسن العبادة، أحمده سبحانه وأشكره وقد أذن لمن شكره بالزيادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تُبَلِغُ صاحبها الحسنى وزيادة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المخصوص بعموم الرسالة وكمال السيادة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيّ حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همّي، إلا أذهب الله همّه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، قال: فقيل: يا رسول الله ألا نتعلّمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها)).
إن الدنيا دار الهموم والغموم والحزن والنصب، والهم والحزن يفتكان بالإنسان ويذهبان بصحته وعافيته، كما قال تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم [يوسف:84].
أي ذهب بصره من شدة حزنه على يوسف وأخيه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهم والحزن. والفرق بينهما: أن المكروه الوارد على القلب إن كان بسبب أمر ماض أحدث الحزن. وإن كان بسبب أمر مستقبل أحدث الهم.وإن كان بسبب أمر حاضر أحدث الغم.
وذهاب الهم والحزن نعمة من أعظم نعم الله عز وجل، ولذا قال تعالى حكاية عن أهل الجنة لما دخلوها: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب [فطر:34-35].
وهذا الحديث حديث عظيم، أرشد فيه صلى الله عليه وسلم أمته إلى الفرار إلى الله بالسؤال والدعاء والذكر عند حدوث الهم والحزن، ولا سيما هذا الدعاء.
وقد تضمن هذا الحديث أمورا من المعرفة والتوحيد والعبودية:
منها: أن الداعي به صدّر سؤاله بقوله: ((إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك))، وهذا يتضمن من فوقه من آبائه وأمهاته حتى ينتهي إلى أبويه آدم وحواء، وفي ذلك تملق له، وانكسار بين يديه، واعتراف بأنه مملوكه وآباؤه مماليكه، وأن العبد ليس له غير باب سيّده وفضله وإحسانه، وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه هلك ولم يؤوه أحد ولم يعطف عليه، بل يضيع أعظم ضيعة.
ومعنى هذا الاعتراف: أني لا غنى بي عنك طرفة عين، وليس لي من أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي أنا عبده.
وفي ضمن ذلك: الاعتراف بأنه مربوب مدبّر، مأمور منهي، إنما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسه، فليس هذا شأن العبد بل شأن الملوك والأحرار، وأما العبيد فتصرفهم على محض العبودية.
وفي التحقيق بمعنى قوله: ((إني عبدك)) التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة، وامتثال أمر سيده، واجتناب نهيه، ودوام الافتقار إليه، واللجوء إليه، والاستعانة به، والتوكل عليه، وعياذ العبد به، وأن لا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء.
وفيه أيضا: أني عبد من جميع الوجوه: صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا وعاصيا، معافى ومبتلى، بالروح والقلب، واللسان والجوارح.
وفيه أيضا: أن مالي ونفسي ملك لك، فإن العبد وما ملك لسيده.
وفيه أيضا: أنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من إنعامك على عبدك.
وفيه أيضا: أني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك، كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده، وإني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.
فمن فهم هذه المعاني وشهدها فقد قال: ((إني عبدك)) حقيقة، وحق له أن يعتز ويفخر بهذه العبودية، كما قال القائل:
ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا
دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيّرت أحمد لي نبيا
فإن في العبودية لله كمال الحرية، وفي الذل له كمال العزة، وفي الافتقار إليه كمال الغنى، وفي الخوف منه كمال الأمن.
ومعنى قوله: ((ناصيتي بيدك)) أي أنت المتصرف في، تصرفني كيف تشاء، لست أنا المتصرف في نفسي، وكيف يكون له تصرف في نفسه مَن نفسه بيد ربه وسيده، وناصيته بيده، وقلبه بين أصبعين من أصابعه، وموته وحياته، وسعادته وشقاوته، وعافيته وبلاؤه، كله إليه سبحانه، ليس إلى العبد منه شيء، بل هو في قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره، بل الأمر فوق ذلك.
ومن علم أن ناصيته ونواصي العباد جميعا بيد الله وحده، يصرفهم كيف يشاء لم يخشهم بعد ذلك ولم يرجهم، وصار فقره وضرورته إلى ربه وصفا لازما له، ولم يفتقر إليهم، ولم يعلق أمله ورجاءه بهم، وحينئذ يستقيم توحيده وتوكله وعبوديته، ولهذا قال هود عليه السلام لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم [هود:56].
وقوله: ((ماض في حكمك، عدل في قضاؤك)) تضمن أمرين:
الأول: مضاء حكمه في عبده.
والثاني: يتضمن حمده وعدله، وهو سبحانه له الملك وله الحمد، وهذا معنى قول نبيه هود عليه السلام ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ثم قال: إن ربي على صراط مستقيم أي مع كونه مالكا قاهرا متصرفا في عباده، نواصيهم بيده، فهو على صراط مستقيم، وهو العدل الذي يتصرف به فيهم، فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله، وقضائه وقدره، وأمره ونهيه، وثوابه وعقابه. فخبره كله صدق، وقضائه كله عدل، وأمره كله مصلحة، والذي نهى عنه كله مفسده، وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمته، وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته.
وقوله: ((عدل في قضاؤك)) يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه، من صحة وسقم، وغنى وفقر، ولذّة وألم، وحياة وموت، وعقوبة وتجاوز، وغير ذلك، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير [الشورى:30].
وقال تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور [الشورى:48].
فكل ما يقضى على العبد فهو عدل فيه.
وقوله: ((أسألك بكل اسم هو لك...)) توسل إليه بأسمائه كلها، ما علم العبد منها وما لم يعلم، وهذه أحب الوسائل إليه، فإنها وسيلة بصفاته وأفعاله التي هو مدلول أسمائه، وقد قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها [الأعراف:180].
ويستفاد من قوله: ((أو استأثرت به في علم الغيب عندك)) أن لله عز وجل أسماء غير التسعة والتسعين المشهورة، والمذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم : ((إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة)).
والمعنى: أسألك أن تجعل القرآن الكريم كالربيع الذي يرتع فيه الحيوان، وكذلك القرآن ربيع القلوب، والمراد أن يجعل قلبه مرتاحا إلى القرآن، مائلا إليه، راغبا في تلاوته وتدبره، منوّرا لبصيرته. فتضمن الدعاء أن يحيى قلبه بربيع القرآن، وأن ينوّر به صدره، فتجتمع له الحياة والنور، كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها [الأنعام:122].
ولما كان الصدر أوسع من القلب كان النور الحاصل له يسري منه إلى القلب لأنه قد حصل لما هو أوسع منه. ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادتها. ولما كان الحزن والهم والغم يضاد حياة القلب واستنارته سأل أن يكون ذهابها بالقرآن الكريم، فإنها أحرى أن لا تعود، وأما إذا ذهبت بغير القرآن من صحة أو دنيا، أو جاه أو زوجة أو ولد فإنها تعود بذهاب ذلك. وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن الكريم هو ربيع القلوب ومادة حياتها، وقد نص على ذلك ربنا سبحانه في قوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا [الشورى:52].
فالقرآن هو روح القلوب وحياتها، به تحيا، وبفقده تموت، كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها [الأنعام:122].
فعليكم بالقرآن يا أمة القرآن ((اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه)).
اقرؤوا القرآن وتدبروه، وأحلّوا حلاله، وحرموا حرامه، وعظموا حدوده، اقرؤوا القرآن فإن قراءة القرآن قربة من أعظم القرب، وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كثرة هذا الأجر بقوله: ((من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: ألم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف)).
اقرؤوا القرآن واجتهدوا في حفظه، فإن العبد يتبوأ منزله في الجنة على قدر ما في صدره من القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها)).
وتعلّموا هذه الكلمات وادعوا بها دائما، عسى الله أن يذهب عنكم الهم والحزن، ويبدلكم مكانه فرحا وسرورا، كما وعدكم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم .
اللهم أكرمنا بالقرآن العظيم وعيا وعملا و أجعله ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ماجهلنا وأرزقنا تلاوته أناء الليل والنهار .اللهم أجعله حجه لنا لاعلينا آمين يارب العالمين